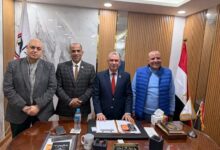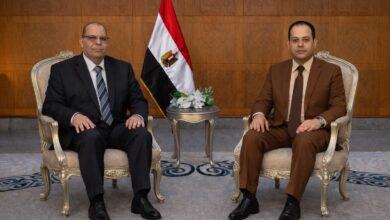يوستينا أشرف
قد أنشأت الصين ومصر حضارتان زاهرتان في تاريخ العالم، وارتبطتا قديما بطريق الحرير الذي وصل بين الشرق والغرب وأسهمتان في تقدم الحضارة العالمية. واليوم، وتحت القيادة الاستراتيجية لقادتي البلدين، تواصل الصين ومصر صداقتهما التاريخية، وتعمقان تعاونهما الاستراتيجي، تسعى الصين ومصر معا لبناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني-المصري في العصر الجديد، وتواجه الدولتان التغيرات المتسارعة والتحديات المتعددة في الوضع الدولي. لقد أصبحت العلاقات الودية التقليدية بين الصين ومصر نموذجًا للتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة بين الدول النامية.
أتقدم بالشكر للدكتورة سحر على دراستها حول تاريخ التبادلات بين الصين والمصرية، خصوصًا خلال فترة ازدهار التفاعل بين أسرة “تانغ” الملكية الصينية والدولة الطولونية في مصر وما تلاها من تاريخ الدولتين، مما ألقى الضوء على عمق الصداقة التي امتدت آلاف السنين بين البلدين.
كما أشكر مكتبة الإسكندرية على دعمها لتعزيز الحوار الثقافي، فالصينيون يحملون مشاعر خاصة تجاه مكتبة الإسكندرية العريقة، وقد تعلمنا عنها منذ دراستنا في المدرسة الاعدادية. وأنا محظوظ لأني لدي الفرص لزيارتها مرارا وتكرارا، وفي كل مرة أتعلم شيئًا جديدًا.
في هذا السياق، أود أن أشارككم بعض الجوانب من التبادل الفكري والثقافي المعاصر بين الصين ومصر، والذي مثّل فصلًا مهمًا في تاريخ حوار الحضارات بين الشرق والغرب. هذه العلاقات لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نمت تدريجيًا عبر طرق الحرير البرية والبحرية، من خلال الروابط الدينية والعلمية والتجارية والسياسية، لتقدم نموذجًا مؤثرًا لتلاقي حضارتين عريقتين على أساس من الاحترام والتبادل والتكامل.
أولًا: الدين والعلم.. جسور الحوار الحضاري
بعد دخول الإسلام إلى الصين في عهد أسرة “تانغ” الملكية، أصبح العلماء المسلمون رسولًا للحوار بين الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية، حيث سافروا للحج والدراسة ودوّنوا ملاحظاتهم، مشكلين قنوات معرفية تجاوزت حواجز الجغرافيا.
مثال من أمثلة رحلات الحج ونقل الثقافة هو المسلم الصيني “ما ده شين” (1794-1874)، إذ قام بالحج إلى مكة، وخلال عودته استقبله السلطان العثماني، ثم ألّف كتابًا بعنوان “رحلة الحج” قدّم فيه وصفًا مفصلًا لعادات وتقاليد في مكة والقاهرة وإسطنبول وغيرها. لم يكن هذا المؤلف مجرد توثيق جغرافي، بل وثيقة حيّة على التفاعل بين الصين ومصر في عهد الدولة العثمانية.
وتلعب الترجمة المتبادلة للكلاسيكيات دورا مهما في تكامل الأفكار. في أوائل القرن العشرين، سافر الفقيه الصيني ما جيان إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر لمدة ثماني سنوات (1931-1939). قام بترجمة “كتاب الحوار” (حوار بين كونفيشيوس وطلابه يتجسد فيه حكمة كونفيشيوس) إلى العربية ونشره في القاهرة، بينما ترجم الكتاب ” رسالة التوحيد” بقلم عالم دين مصري محمد عبده إلى الصينية، مما أتاح حواراً عميقاً بين فلسفة الكونفوشيوسي والفلسفة الإسلامية. وقد وفرت هذه الترجمة الثنائية جسراً للتواصل بين الجوهر الروحي للحضارتين.
ثانيًا: السياسة والنضال.. صدي المصير ضد الاستعمار
في النصف الأول من القرن العشرين، أصبحت الصين والعالم العربي من حلفاء بشكل طبيعي في مكافحة المستعمرين، فأصبحت المؤازرة السياسية بُعدا رئيسيًا في التبادل بيننا.
شارك الشعبي الصيني والمصري في الوعي بالأزمة التاريخية. اهتم المثقفون الصينيون في أواخر عهد أسرة “تشينغ” الملكية بخبرات مصر. في عام 1903، ترجم الثوري الصيني تشاو بي تشن الكتاب “تاريخ مصر” وحذّر على الشعب الصيني أن يأخذ درسا من الاستعمارية البريطانية والفرنسية في مصر من أجل تعظيم نهضة الصين”. كما درس رائد من رواد نهضة الصين كانغ يو وي من إصلاحات التنظيمات في الدولة العثمانية خلال زيارته لمصر، داعيًا الصين إلى اتباع نهج مماثل.
ودعمت الصين والعالم العربي بعضه للبعض اثناء الحرب العالمية الثانية. قدم العالم العربي دعمًا معنويًا للصين خلال للصين، وتطوع ضباط متقاعدون وأطباء عرب لمساعدة الصين في الحرب ضد الغزو الياباني، مجسدين تضامن الشعوب المضطهدة رغم البعد الجغرافي.
ثالثًا. التجارة والموارد: روابط الاقتصاد خارج المركزية الغربية
أدى ازدهار طريق الحرير البحري إلى نموذجًا تجاريًا فريدًا بين الصين ومصر وإعادة تشكيل التدفقات الاقتصادية العالمية خارج المركزية الغربية بسبب قلة تأثره من الاستعمارية الغربية.
ومن نواحي هذا النموذج هي التفاعل المتبادل في التقنيات الزراعية. في أواخر القرن التاسع عشر، قامت مصر بزراعة كميات ضخمة من فول الصويا القادم من شمال شرق الصين من أجل مكافحة دودة اللوز القطنية. لذلك امتدت سلسلة توريد فول الصويا من بحر الصين الجنوبي مرورًا بمضيق ملقا والمحيط الهندي وصولًا إلى قناة السويس، مشكّلة شبكة إمداد عابرة لنصف الكرة الأرضية.
وتتجسد خصائص النموذج التجاري هذه أيضا في التكامل والتكافؤ في الصناعات اليدوية. فاعتمدت صناعة السجائر المصري على التبغ الصيني كمادة خام، وصدّرت سيجارها إلى الأسواق العالمية. وكانت الصين تستورد من مصر منتجات خاصة بشمال إفريقيا. هذه المبادلات القائمة على الخصائص الطبيعية لكل طرف، شكّلت تحديًا للرواية الاقتصادية الغربية المتمركزة حول ذاتها
رابعًا. الرموز الثقافية: تشابه الجذور الحضارية
رغم اختلاف الزمان والمكان، أظهرت الحضارتان الصينية والمصرية تشابهًا روحانيًا يعكس منطقًا إنسانيًا مشتركًا في فهم الكون.
يتجسد التشابه في تجسيد السلطة. جمعت نقوش “الإنسان والوحش” في ثقافة ليانغتشو (3300-2300 ق.م) بين الإنسان والكائنات الأسطورية مثل أبو الهول، لتأكيد السلطة الدينية والدنيوية.
وبالنسبة للرؤية الكونية، تماثلت الأواني اليشمية المخروطية في الصين مع المسلات المصرية كرموز للتواصل بين الأرض والسماء، حيث تشابه طقوس “تقديم اليشم الأزرق للسماء والأصفر للأرض” مع النقوش الشمسية والقمرية على المسلات.
خاتمة: إضاءات للحاضر من حوار الحضارات
من رحلة الحج التي كتبها ما ده شين، إلى المساعدات المتبادلة في الحرب ضد الغزاة، ومن ترجمات الكلاسيكيات الكونفوشيوسية، إلى فول الصويا الصيني المزروع على شواطئ البحر الأحمر، تؤكد العلاقات التاريخية بين الحضارة الصينية والحضارة المصرية أن حيوية الحوار الحضاري تنبع من تفاعل ثقافي شعبي عفوي وإرادة مشتركة لمقاومة الهيمنة.
إن هذا النوع من التبادل القائم على الاحترام والمساواة، شق طريقًا جديدًا للتعايش الحضاري بعيدًا عن النظام الاستعماري الغربي. وكما هو الحال في بناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني-المصري في العصر الجديد، فإن جذوره مغروسة في هذا التاريخ العابر للزمن من التفاعل الحضاري.
لقد أثبتت هاتان الحضارتان العريقتان، عبر الحكمة والصلابة، أن التواصل الحقيقي لا يحتاج إلى هيمنة، بل يزدهر في ظل التبادل المتكافئ، ويضيء سماء الحضارة الإنسانية بالتنوّع والتكامل.